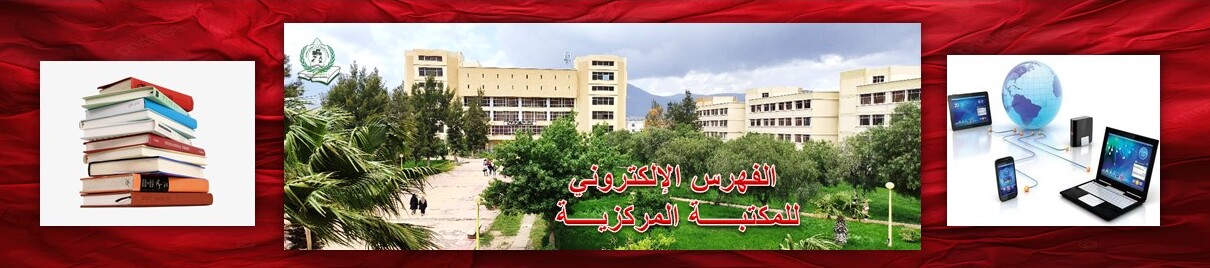| Titre : | الإستبداد بالحكم و أليات مواجهته : دراسة مقارنة لنيل درجة الفكر السياسي الإسلامي و أنظمة الحكم الحكم العربية الإسلامية |
| Auteurs : | شرفي، صالح الدين ; بوترعة، محمود |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | جامعة باتنة 1 |
| Année de publication : | 2018/2019 |
| Format : | 473 ص. / 29 سم. |
| Note générale : | قرص مضغوط |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 210 (sciences islamiques) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الحكم ; الإستبداد ; أليات مواجهة الحكم |
| Résumé : |
يعالج البحث موضوع الاستبداد الذي عانت منه الشعوب على مر. التاريخ، والعديد منالحكام الذين تولّوا السلطة منذ القدم حاولوا تبرير سلطتهم المطلقة بداية من النظريات الإلهية التي تقدس الحاكم وفرعون الإله نموذج لهذه النظرية التي عارضها الفكر السياسي الإسلامي بشدة، وفيتاريخنا الإسلامي وبداية من العهد الأموي استغل الحكام الفقه لتبرير وشرعنة استبدادهم، فكان للاستبداد فقه خاص به، بداية من طاعة الحاكم المطلقة، التي تتعارض مع القرآن والسنة اللذان يثبتان أنه لا طاعة لحاكم في معصية، وكلاهما ينهي عن الركون للظلم والظالمين، كذلك نجد تبريرا للاستبداد من خلال إضفاء الشرعية لولاية المتغلب وجعلها من الطرق الشرعية لتولي السلطة، وهذا يتعارض مع الحكم الشوري الذي يتطلب رضا الأمة، وهذا الذي سار عليه الخلفاء الراشدون، فالإسلام بمبادئه الذي يحمي الحقوق والحريات المشروعة للأفراد يتناقض مع الاستبداد والتسلط. ولأن البشر معر.ضون للخطأ واتباع الهوى ومن ثم الوقوع في الاستبداد، فإنّ كل من الفكر السياسي الإسلامي والقانون الدستوري الجزائري وضعا ضمانات للحد من استبداد الحاكم، تنقسم لضمانات وقائية تتمثل أولا في مبدأ الفصل بين السلطات، وهو مبدأ دستوري حديث أقر.ته الكثير من الدساتير ومنها الجزائر، إلا أن هذا المبدأ من الناحية النظرية مغي.ب نظرا لأن رئيس الجمهورية في الجزائر يتدخل في صلاحيات السلطة التشريعية والسلطة القضائية. أما بالنسبة لنظام الحكم في الإسلام فإن.ه لم يعرف هذا المبدأ؛ لأنّ الخليفة كان يجمع بيده كل السلطات باعتباره مجتهدا، لا باعتباره حاكما، كما أنّ الحاكم في الإسلام وإن مارس القضاء فهو والمحكومين سواء أمام القضاء، مع أنّ الفكر السياسي الإسلامي يجيز الأخذ .ذا المبدأ لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة، ولأنه يحقق مصلحة عامة للمسلمين في الوقاية من الاستبداد. والضمانة الوقائية الثانية تتمثل في تحديد العهدة الرئاسية التي يقرها الدستور الجزائري المعدل في 2016 ، غير أنّ معظم الدول العربية تعاني من أزمة تعديل الدساتير لصالح فتح العهدات الرئاسية دون تحديدها، وهذا ما حدث في الجزائر في التعديل الدستوري لسنة 2008 . أما بالنسبة لنظام الحكم في الإسلام فإن.ه عرف تأبيد مدة الحكم، فالخليفة لا يترك السلطة حتى وفاته، هذا الذي استغله المستشرقون في ا.ام الإسلام بالنظام الاستبدادي، وهذا ا.ام باطل لأنه توجد عدة قيود تمنع الاستبداد حال تأبيد مدة الحكم أهمها مسؤولية الحاكم أمام الله وأمام الأمة عن كل أخطائه، كما أن الفكر السياسي الإسلامي يجيز تحديد مدة رئاسة الدولة؛ لأنه لا يوجد دليل يمنع ذلك. والضمانة الوقائية الثالثة تتمثل في الشورى التي يتميز .ا نظام الحكم الاسلامي، ورغم اختلاف الفكر السياسي الإسلامي حول وجو.ا، إلا أنه ترجح للباحث أن الحاكم وجب عليه استشارة أهل الاختصاص في كل ما يقوم به من أعمال، وأن الشورى الملزمة هي التي تمنع الاستبداد. وفي الجزائر توجد عدة مؤسسات يستشيرها رئيس الجمهورية، إلا أن هذه الاستشارة من الناحية العملية غير فعالة لأ.ا غير ملزمة له، كما أن هذه المؤسسات الاستشارية والمتمثلة في ا.لس الدستوري، ومجلس الدولة، والبرلمان، هي تابعة في قرارار.ا لتاثير الرئيس. الضمانات الأخرى علاجية أي بعد انحراف الحاكم ترجعه إلى الصواب، وأولها الرقابة على تصرفات الحاكم، والفكر السياسي الإسلامي يتميز في أن الرقابة تبدأ قبل تولي الس.لطة من خلال فرض شروط على من يريد الترشح للرئاسة، وتستمر هذه الرقابة إلى مرحلة ممارسة السلطة من خلال وسائل قديمة تتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحق الحاكم في النصيحة من الأمة، ووسائل حديثة أقرها الفكر السياسي الإسلامي بضوابط وشروط وقيود تتمثل في رقابة الأحزاب، ورقابة الإعلام. وبالنسبة للرقابة على الحاكم في الجزائر فإ.ا رقابة ضعيفة وغير مؤثرة بسبب هيمنة رئيس الجمهورية على كل السلطات في الجزائر، كما يرجع ذلك إلى سيطرة الحزب الحاكم على مفاصل الحكم منذ الاستقلال، وبالتالي لاتوجد معارضة حقيقية تلعب دورا في الحد من الاستبداد إذا وقع، فضلا عن ذلك تبعية البرلمان لسلطة الرئيس، وضعف مكانته الرقابية. والضمانة العلاجية الثانية تتمثل في إقرار المسؤلية عن أخطاء الرئيس، التي ينفرد الفكر السياسي الإسلامي عن غيره ،كون الحاكم في الإسلام بالإضافة إلى مسؤولته أمام الأمة فهو مسؤول أولا أمام الله، ومن ثمرا.ا تقييد تصرفات الحاكم بما يرضي الله، وهذا سبيل للحد من الاستبداد لأنه دائما يستشعر عقاب الله. وإذا لم تنفع هذه الضمانات في منع الاستبداد، فإن الأمة ومن خلال التجارب قد تلجا إلى مواجهة الاستبداد عن طريق الثورات، إما سلميا كما حدث في ثورة 25 يناير المصرية، والفكر السياسي الإسلامي اختلف حول مشروعية ذلك بحسب الموروث الفكري لكل فريق، والذي ترجح للباحث أنه تجوز الثورة السلمية لمواجهة الاستبداد لأ.ا ليست الخروج المنهي عنه في الحديث، وذلك إذا توفرت الضوابط والشروط أهمها أن لا تكون مدعاة للفتن، وأن تكون بوسائل مشروعة، وإما عن طريق الخروج المسلح كما حدث في ليبيا ثورة 17 فبراير، وهو محل خلاف فكري قديم أيضا، إلا أنه في عصرنا هذا يرى الباحث الابتعاد عن السلاح والقتال لما فيه من مفاسد عظيمة ودرأ المفاسد أولى من جلب المصالح، والسبب الآخر هو عدم توفر القدرة المادية لمواجهة الجيوش النظامية؛ لذلك فإن اللجوء إلى الثورة المسلحة يدخل البلاد في دوامة عنف لا .اية لها إلا بالخراب وسفك الدماء ومزيد من القتل والدمار. وفي الحالة الليبية اعتبر كثير من أهل الفكر الإسلامي أن الذي حدث ليس خروج على الحاكم وإنما هو قتال الضرورة للدفاع عن النفس، إلا أن طلب الاستعانة بالقوات الأجنبية هو دعوة لاحتلال البلد كما اعتبر ذلك المفكر الصلابي. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| THE/19/715 | D/210/231/ | Thése | BU Centrale Batna 1 | Premier étage : Thèses et mémoires | Exclu du prêt |